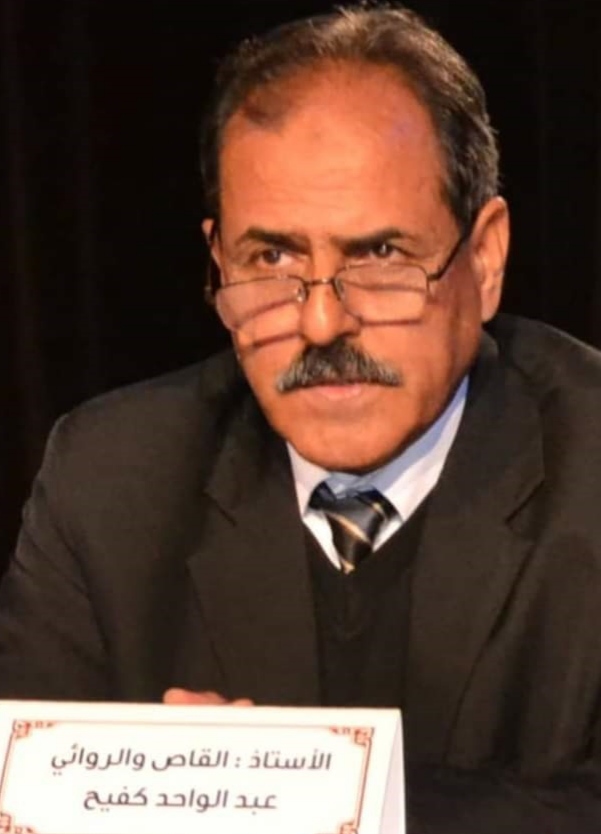
ذ عبد الواحد كفيح / قاص وروائي مغربي
مازالت سرود الروائي عبد الكريم جويطي تستأثر باهتمام المبدعين والنقاد على السواء. فما من عمل جديد لديه إلا ويثير فضول القراء ويحفّز شهية القراءة ويشجع على التفاعل والمتابعة. وما يزال ماض في مشروعه الروائي الملتزم بقضايا المجتمع والعصر، في قالب إبداعي يرصد جوانب اجتماعية، يكشف فيها عن الدواخل والبواطن خاصة فيما يتعلق بتلك العاهات الجسيمة والتشوهات الموجعة التي عرّاها بصدق وصراحة إبداعية راقية في روايته ” المغاربة” التي لم يقف فيها حدّ رصد الواقع فحسب، بل يحيلنا بأحداثها ضمنيا، على ضرورة الثبات على المبادئ وتجذير القيم السامية وألا تهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة في المواقف المناسبة
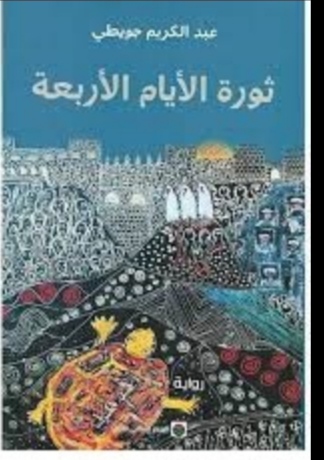
وتأتي روايته الأخيرة ثورة الأيام الأربعة لتتوج مسيرة إبداعية طويلة، ظل فيها جويطي وفيا لجنس الرواية، مفضلا إياها عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى، حيث لم يبغ عنها حولا ولا عوجا، إذ يعتبر الوحيد الذي أخلص للرواية واتخذها له ملة وعقيدة وما حاد عنها ولا بدّل تبديلا، سوى في محاولة منه لاستغوار واستكشاف مراحل تاريخية، وحقب زمنية هامة من تاريخ المغرب، والتي أثمرت عن إنتاج عمل ضخم، في قراءة رصينة واستقراء علمي دقيق لتاريخ تادلة بالخصوص، ومن أحداثها أكيد استبطن حقائق جوهرية أثرت خبرته، وعملت على إيقاظ الشعور في استلهامها روائيّا دون إكراه ذاتي ولا تكلف إبداعي مصطنع
وفي ثورة الأيام الأربعة التي أفضل أن أعنونها ب “حلم الجمهورية الموءود”، حيث اختار الكاتب لأحداث روايته ، وبذكاء إبداعي هادف، الجبل كفضاء له أبعاده الدلالية والرمزية، وراهن عليه باعتباره كان وما يزال عمقا استراتيجيا ومعقلا للنضال والمقاومة المغربية الشرسة، وهو الذي يعلم دون سواه، أنه من هناك تأتي أنباء الأمم المنتصرة وأشلاء الأساطير البطولية. ومن هناك استعر أوار المقاومة والتمرد على المستعمر وحيث ولد أبطال الجبل الصناديد الأشاوس. فاتخذه أرضية صلبة ومنطلقا لاندلاع أحداث رواية مبهرة من حيث جودة الأسلوب وقوة الطرح وعمق المعنى ، إذ منذ بداية الفصل الأول نلفيه يغوص عميقا في فيض غزير من الدهشة اللغوية والإمتاع السردي الزاخر بالأحداث، مستعيدا لحظات مستقطعة من الذاكرة في مزيج خاص بين الأشياء والأشخاص والأحداث الواقعية منها والمتخيلة والأماكن، في محاولة منه، في اعتقادي، للهدم والترميم والتدمير وإعادة البناء والإنشاء، مستغلا مساحات هائلة لا حدود لها من التخيّل والخيال. وقد شيّد عالمه الروائي في أماكن وفضاءات قريبة جغرافيا، من عالمه الصغير (بني ملال) التي يدرك بالتأكيد شعابها ووهادها ووديانها ” إيريس”، فكان أن استحوذ المكان على جزء كبير من الرواية باعتباره مأوى وحيزا لصدى الأرواح، بل موطنا ضاجّا بالأرواح والروائح والخبايا التاريخية الناطقة بكل الألسن واللغات. لهذا كانت الأماكن بطبيعتها الجبلية الساحرة عنصرا من عناصر الدهشة والإمتاع التي تحفل بها الرواية
مع توالي تسلسل الأحداث تتبدّى للقارئ بعض الحقائق والراوي يميط أستار الإبهام وسجوف الغموض الذي يبدأ في التلاشي مع توالي الصفحات، فتتكشّف أسرار الحكاية، وتنكشف هوية الشخصيات بدءا من دوغول، هذا علاوة على إماطة الإبهام واللبس عن لغز الأغنية المشؤومة التي كانت سببا في مأساة أستاذ الفلسفة وكتيبة الثوار الثمانية الآخرين ، حيث كل واحد منهم يحمل في عبّه سرا دفينا بل أسرارا، والذين بدأت ملامحهم تتشكل بعد عملية سردية تتغيّى الإرجاء والتأجيل، في لعبة الكرّ والفرّ، وشد وجذب، وتحريض لدودة التشويق، والراوي يتنقل بنا على جناح الإمتاع عبر الأزمان والعصور، والكائنات الروائية، والمذاهب الفلسفية، والتيارات السياسية وأنظمة الحكم. إذ على القارئ أن يلتهم مائة صفحة للتعرف على البطل أستاذ الفلسفة زياد السمعلي وسليمان الفحام وعمر الكتبي و (ر.ب. م)/ (رجاء بني ملال)، والمعلّم والفيتنامي، وكل الكائنات الروائية التي تشكل عصب فصول الرواية بما فيها “سرمد” الذي أكيد يحيل على البطء بل توقّف الزمن، ومؤشرا واضحا على أن هؤلاء الفتية الذين آمنوا بثورة فاشلة، وهم يعضون بالنواجد على مؤشرات الهزيمة والفشل قبل البداية، لا محالة هم ساقطون آجلا أم عاجلا. وأكيد يعلمون علم اليقين أن بدايتهم و منطلقاتهم خاطئة وخاسرة، ستقودهم حتما إلى نهاية فاشلة وخط وصول خاطئ
في العديد من المواقع نلفي الكاتب يروض اللغة ترويضا، بحس جمالي لا يحمّل اللغة عبئا بقدر ما يدع المتلقي أسيرا لبلاغتها وبذخها الشاعري. لهذا، وبهذه المؤهلات اللغوية، ومقدرته الهائلة على تطويعها يجد القارئ نفسه يسبر أغوار الشخصيات ويتكشّف ويتقرّى أفكارها وأحلامها وانكساراتها. ولإعطاء المشروعية لثورة ما يحرص مهندسوها على تنويع الفئات المشاركة/ المتورطة إثباتا منهم لدواعي ومبررات الثورة والاستياء العارم من فشل منظومة النظام ككل. فينبري الراوي في تبرير اختفاء وموت أو اغتيال شخصيات سياسية قيادية كتب لها أن تختفي من سجل التاريخ الكبير، وتطمس ذكراهم إلى الأبد بأسلوب أدبي رفيع، مشوق يشد الأنفاس بشغف كبير. وبعد أن غاض وغاب مؤشر الانتصار، – وبوادر فشل ذريع تتبدى للعيان- تمنى الراوي أن يعود إلى نفسه وإلى براءته الأولى (ص 93)
تناقش الرواية أفكارا كبرى في العديد من تمفصلاتها، وهي كثيرة وفيها ما قدمه بسخرية سوداء لاذعة ص (103) كل هذا في ثورة غريبة هجينة بلا ملامح وليست ككل الثورات (ص )104(ص /111ص)، لدرجة أنه استعصى على المترجمين أن يجدوا لمعناها – في الكتب واللغات – ما يقابله بالأمازيغية، في إشارة ذكية إلى عماء الثورة والثوار وضلالها وغموضها وغرابتها منذ الانطلاقة الأولى لإطلاق أول رصاصة. ففيها إشارات بليغة لعنصر الهاجس الأمني لدى الجهات المسؤولة جراء الخوف الذي شيدت حوله الحدود والسدود والأسوار العالية عوض بناء المجتمع الذي أضحى سجين وطنه.
وهم في قلب الحدث، وفي اللحظات الحاسمة، وفي جلسة حوار مع الذات أو سلخ الجلد، اكتشف الثوار أنهم في وضع سيئ لا يحسدون عليه، وأن كل المؤشرات السلبية التي توجد بين أيديهم وأمام أعينهم تشي بخسارة فادحة، وأنهم على وشك طي صفحة ثورة لم ولن يدوّن فيها سطر واحد على الإطلاق
في استعادة للأحداث و استغوار عميق للذاكرة، حيث الأغنية المشؤومة وبداية المواجهة مع المخزن، وفي انتقالات سردية سلسة تخرجك من عالم الكائن الموجود إلى العالم الذي كان، سعى الكاتب بلغة باذخة، وحرفية إبداعية عالية الصبيب، إلى الإمساك بخيط السرد و بخناق القارئ حتى آخر نفس من الرواية، هذا علاوة على قدرته الرهيبة على التحليل، والمناوشة، و الاستشهادات، والمقارنة والاستنتاج والتوقع، وثقافته الواسعة، هي التي جعلت من كتابات جويطي الروائية مرآة وسجلا إبداعيا غنيّا سيتوارثه المهتمون بجنس الرواية، لأن كتابة الرواية كما يقال، تحتاج الى الكثير من الحقائق التي توجد بين ثنايا سجلات التاريخ وخرائط الجغرافيا والفلسفة وغيرها من العلوم الحقة وكذا علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم الانسانية التي ينبغي لكل روائي الإحاطة بها والتمكن من بعض جوانبها وخصائصها، وهو أكيد لديه الكثير الكثير منها .إذ تلفيه في الرواية متمكنا محيطا بالفكرة والقدرة الفائقة على طرح الشيء ونقيضه ص (167) يقلبها ذات اليمين وذات الشمال ويضعها تارة بالتصريح على محكّ التشريح وتارة بالتلميح مناوشا، تاركا مساحة أوسع لرأي القارئ وإشراكه في الاستنتاج ويدفعه بهذا ليكون منتجا مؤولا، لا مستهلكا سلبيا كما في ص (168) حيث يدعو – وهو المهتم بالتاريخ – إلى إعادة كتابة التاريخ، وإعادة النظر في التاريخ الذي يوجد في السجلات الكبرى، داعيا على لسان القائد الذي طلب من الأستاذ أن يكون مؤرخ وموثق هذه الثورة. ولعل البعد الدلالي للمفكرة ورمزية المنظار لا تخطئهما البديهة (التاريخ والجغرافيا)، وأن يوثّق بمنظار أشدّ دقة مما يراه الآخرون العاديون (مؤرخو البلاطات) ص (169) وفي إحالة أخرى أيضا على أن الإبداع الحقيقي هو تصوير واستغوار لكل الاشياء التي يمر عليها الآخرون العاديون ولا تثير لديهم فضول الاستغوار والتمحيص والاستنتاج والتأويل
عاش البطل في رواية ثورة الأيام الأربعة حالة من الرعب والانكسار والانفصام بين ما يسمعه وما يراه ، فأضحى فريسة لأفكار باتت تفتك به وهو يستحضر مهندسي الثورات في كراسيهم الوثيرة وأماكنهم الآمنة بعيدين جدا عن مواقع المخاطرة والمغامرة والمقامرة أحيانا، فيما العكس هو الصحيح أن يقودوا الثورة ويخوضوا التجربة في الطليعة بصدور عارية ليختلط فعلا الدم باللحم والمصير، فبدا أنه بحاجة إلى مساءلة الذات والقيام بثورته الخاصة كما شخصية تودا (صاحبة الماخور) التي قررت هي الأخرى أن تتمرد على حياتها، فيخلص في العديد من محطات وتمفصلات الرواية إلى أن الثورة الحقيقية التي ينبغي القيام بها هي ثورة على الجهل والسذاجة والايمان بالغيب وتحطيم الأصنام، وعلى التعاسة التي ترافق الأشخاص، وعلى الذات قبل أي ثورة أخرى، وكما أنه لا يستحق مثل هؤلاء أن يخاطر المرء بنفسه من أجلهم في انتحار رخيص، وهو يحفر قبره بيده بل يستلقي فيه ويهيل عليه التراب ص( 270)
في تقابل إبداعي جميل، يحيل على صبر ووفاء بينيلوب وانتظارها عودة عوليس من عوالم الأساطير المدهشة وعرائس الاوديسا، وهي تغزل الصوف وتنكث ما غزلته في إشارة جميلة جدا لصبر الأمهات والزوجات اللواتي جلسن على الربوة في أوقات معلومة ينتظرن عودة الأبناء والأزواج من لاندوشين وقد انتهت الحرب هناك منذ سنين عديدة خلت وهن يغزلن ولا يتوانين في الإصرار على التشبث بخيط الأمل في انتظار أزلي مزمن حتى وإن علمن أن الحروب فعلا قد انتهت، وكل واحدة فيهن تحمل في عبّها سرّا دفينا كما هو الحال لدى باقي شخصيات الرواية حيث كل واحد منهم يحمل سرا غير مقدرين عواقب الانتظار والأسرار والألغاز التي تنتظرهم جميعا.
ويعد مشهد النساء اللواتي قضين الساعات والليالي الطوال منتظرات، بلوعة حارقة، ذاك الذي يمكن أن يأتي ولا يأتي، في حالة ترقب أبدية من اللوحات التي وردت بحضور قوي لافت في جمالية الرواية، كل ذلك في سرد مكثف غزير استند فيه الكاتب لقالب روائي شيق ومنتظم البُنى، مستعرضا بحنكته السردية المعهودة أحداثا مضت وحدثت في الواقع وانقضت وتبخرت في لمح البصر وكأنها لم تحدث أصلا (أحداث مولاي بوعزة) محاولا في اعتقادي، ربط الماضي بالحاضر ومساءلة التاريخ القريب، وما يقابل كل هذا من وشائج التشابه التي تشكل معطيات حاضرنا، وما يرافق ذلك من استعادة لمواقف جريئة وأحداث تاريخية موجعة مازالت تستوطن الفكر وتحفر عميقا في العقل، وترفض المغادرة، محاولا التّأريخ لما أهمله التاريخ الرسمي. كل ذلك في إبداع روائي شيق جديد، في حلة جديدة، وبوعي جمالي جديد وتيمة جديدة، فيها عدد هائل من الأسئلة المبطنة والشفرات والايماءات والإجابات المعلقة، والإحالات المشفرة في إشارة صريحة وبليغة لمقولة في قلب كل رواية سؤال أو إشارة أو استفهام
نحن إزاء رواية تستنطق – بسخريتها السوداء- المسكوت عنه في ذواتنا الفردية والجمعية، وتذكّر بالمنسي فينا وفي تاريخنا وتفجره. وفي سياق كل تلك الأحلام الموءودة، والمفارقات الغريبة التي استوطنت مواقع عديدة من الرواية، استطاع الكاتب أن يخلخل الجاهز والمسكوك والمسكوت عنه، وكل الأشياء المركونة في خانة المسلمات حتى تكتسب قيمة ومعنى ودلالة جديدة وآنية، غير متحمس ولا متوان في ترتيبها ترتيبا مختلفا وتقليبها بعين المبدع الناقد المؤرخ ذات ظاهر وباطن، في سياق يحيل على مجمل العلل العميقة الظاهرة للعميان، التي لازمت مشروع هذه الثورة العمياء، أنه ليست بالأحلام – التي ظلت أفكارا بعيدة سنوات ضوئية على خط التحقق- تنال المطالب، خاصة أنها انطلقت بلا خطة، ولا بوصلة، ولا خرائط، ولا تواصل، وما صاحبها أيضا من بطء “سرمدي”
ومع التوغل في مجريات أحداث الرواية تتقافز الأحداث والوقائع التاريخية الحقيقية في تسلسل سردي شفيف، لا يغلب فيها التاريخي على المتخيل، ولا هذا عن ذاك، وهو المفتون باستغوار وتمجيد تاريخ سهول تادلة الممتدة جذوره في غور سحيق من الزمن السرمدي الجبار، علما أنه بالنسبة لجويطي لا يقينيات في الرواية ولا حدود فيها للتأويل والشك والارتياب، متناولا كل ذلك بنظرة مغايرة للأشياء والأحداث العادية، موظفا في ذلك حفرا أركيولوجيا في الذات والأحداث، سالكا بذلك طرقا غير معبدة وغير مألوفة وغير عادية للوصول حتما إلى محطات عذراء وغير مألوفة ولا مطروقة، مناوشا تارة بنقد ناعم و واضعا الاصبع بقوة على مكمن الداء بما فيها العديد من الهموم الذاتية والجماعية والقلق المزمن والصراع الأبدي المتأصل في الذات الانسانية من أجل العيش وإثبات الوجود. وأخيرا تعدّ هذه الرواية إضافة نوعية للمكتبة المغربية والعربية في المنجز الروائي الجديد، مازالت في حاجة الى المزيد من القراءات والدراسات النقدية العميقة والمتفحصة لاستغوار زواياها المعتمة، وتسليط الضوء على الجوانب الفنية والجمالية للمنجز السردي ككل لروائي محترف أصيل، بصم على حضور إبداعي وازن ومميز
 الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين
الخبر الجماعي الخبر الجماعي …أخبار خريبكة … الخبر اليقين




